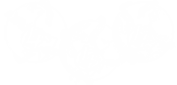المغرب العربي :
الشعوب في مواجهة الإمبريالية
والقادة في بلادها
حلقة ليون تروتسكي
باريس في 10 مايو 2025
في 30 يوليو 2024، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، تلقى ملك المغرب محمد السادس هدية من إيمانويل ماكرون تتمثل في اعتراف فرنسا الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إلا أن هذه المستعمرة الإسبانية السابقة هي موضع نزاع بين المغرب والصحراويين الاستقلاليين في جبهة البوليساريو، المدعومين من الجزائر.
وضعت هدية إيمانويل ماكرون هذه حدا للـ”برودة“ التي سادت بين فرنسا والمغرب منذ الفضيحة التي كشفت أن المملكة كانت تتنصت، بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي ”بيغاسوس“، على العديد من الشخصيات، من بينها رئيس الجمهورية.
وإذا كان هذا الإعلان قد أدى إلى تحسين العلاقات مع المغرب، فإنه أدى في المقابل إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين فرنسا والجزائر. وفي البلدان الثلاثة، استغلت التوترات لتشتيت الانتباه عن السخط الاجتماعي وتعزيز الشعور القومي.
اتهامات بالتجسس، وسجن الكاتب بولعام سنسال، كما قضية المؤثرين الالكترونيين، وجريمة مدينية مولوزMulhouse، وترحيل الجزائريين بموجب أوامر إعادة التوطين، والتهديد بإلغاء اتفاقيات 4 ديسمبر 1968، واختطاف المؤثر أمير دي زد، وطرد القناصل، كل هذه الأحداث، التي تليق بمسلسل بوليسي، أثارت جدلا تم استغلاله لأغراض سياسية داخلية في فرنسا.
فوزير الداخلية، برونو روتايو Bruno Retauillau، الذي يخوض حملة لرئاسة حزب اليمين الجمهوري (LR) ولديه طموحات رئاسية معلنة، أذكى نار الخلافات من أجل فرض نفسه داخل حزبه وفي مواجهة منافسيه من اليمين المتطرف. بل إنه تفاخر بأن كل خلاف جديد مع الجزائر قد أدى إلى تعزيز شعبيته.
وحرصا منها على عدم السماح لأحد بتجاوزها من اليمين، طالبت مارين لوبان بتجميد تأشيرات الدخول الجزائريين ومنع التحويلات المالية للجزائريين المقيمين في فرنسا نحو الجزائر، ووعدت، في حال وصولها إلى السلطة، بـ«معاملة الجزائر كما فعل ترامب مع كولومبيا".وعندما تم إرسال جان لوي بارو إلى الجزائر في أوائل أبريل لتهدئة الأزمة، تعرض لانتقادات شديدة من اليمين المتطرف، الذي اتهمه بـ ”الانصياع للديكتاتورية الجزائرية“.
هذا التصعيد المثير للاشمئزاز يندرج في إطار الحملة المعادية للمهاجرين التي تقودها هذه الحكومة، كما فعلت الحكومات التي سبقتها. ذلك دون أي اكتراث بإذا كانت هذه الحسابات السياسية تتعارض مع مصالح أرباب العمل الفرنسيين المتمركزين في الجزائر والذين أصابهم الذهول من هذه الحملة الهستيرية. وذلك دون أي اكتراث بمصير جميع العمال الجزائريين أو من أصل جزائري، الذين يقعون بين المطرقة والسندان، بين سلطتين، والذين سئموا من الوصم بالعار وتصويرهم على أنهم أصحاب امتيازات ومجرمون.
هذه الخلافات الدبلوماسية تهدف إلى صرف الانتباه عن السخط الاجتماعي، وهي لا تخدم مصالح أي عامل، سواء في فرنسا أو في الجزائر. على العمال الواعين أن يعارضوا هذه الحملة الكارهة! فأيها العمال من مختلف الأصول، نتشارك نفس أرباب العمل، فلنتشارك نفس النضال!
تكشف هذه الأزمة مدى استمرار تأثير الماضي الاستعماري. على الرغم من حصول شعوب المغرب العربي على الاستقلال منذ أكثر من ستة عقود، فإن سيطرة الإمبريالية، وفي مقدمتها الإمبريالية الفرنسية، على هذه المنطقة لم تتوقف أبدا. وسرعان ما خاب أمل الشعوب التي كانت فخورة بتحررها من الاستعمار. فبينما كانت تأمل في حياة حرة وكريمة، وجدت نفسها في مواجهة قادتها، الذين أصبحوا مضطهديها الجدد. ورغم أن الدول الثلاث الجديدة المستقلة – المغرب وتونس في عام 1956 والجزائر في عام 1962 – كانت مختلفة في شكلها، فإن كل نظام من الأنظمة التي نشأت بعد الاستقلال استخدم نفس الأساليب لقمع الاحتجاجات التي لم تتأخر في الظهور. في نهاية المطاف، كان كل من هذه الدول الجديدة، بطريقته الخاصة، مدافعا عن النظام البرجوازي وضمينا للنظام الإمبريالي.
|
 |
تضم منطقة المغرب العربي خمس دول رسمية هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى الصحراء الغربية التي استعمرتها إسبانيا ولم تحرر بعد.
يعيش 110 مليون نسمة في هذه المنطقة الواقعة على مفترق طرق ثلاث قارات، أفريقيا وأوروبا وآسيا، والمحاطة بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء الكبرى الشاسعة. سنركز بشكل أساسي على بلدان المغرب الأوسط الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الصحراء الغربية التي يرتبط مصيرها بالبلدان السابقة وتشترك شعوبها في تاريخ طويل. لقد استعمرتها فرنسا وإسبانيا وخاضت كفاحا شاقا من أجل نيل استقلالها. وقد تأثرت هذه الكفاحات ببعضها البعض. اللغة العربية الرسمية هي لغة مشتركة، كما أنهم يتشاركون نفس لغة التواصل، وهي العربية المغاربية الشعبية، بالإضافة إلى اللغة البربرية التي تتفرع إلى العديد من اللهجات. إنهم يتشاركون نفس الثقافة ونفس التطلعات، وكان من المفترض أن يكون لهم مصير مشترك، ولكن الأمر لم يكن كذلك.
فمنذ الاستقلال، تعاني شعوب المغرب والجزائر من الخصومات التي تدور بين قادتها. كانت هذه الخصومات موجودة، حتى قبل الاستقلال، في مشاريع القادة القوميين الذين كانوا يسعون إلى بناء دولتهم الخاصة. وقد أذكت الإمبريالية الفرنسية، التي لم يكن في مصلحتها أن تواجه كيانا موحدا واسعا، هذه التوترات شبه الدائمة بين أكبر دولتين في المغرب العربي، المغرب والجزائر.
يمكننا القول بأن نضال شعوب المغرب العربي ضد الاضطهاد هو تاريخنا نحن العمال على جانبي البحر الأبيض المتوسط. أولا لأن الاستعمار الفرنسي ترك بصمة دائمة هناك، وثانيا لأن فرنسا لعبت دورا أساسيا في إقامة هذه الدول المستقلة، وأخيرا لأن جزءا كبيرا من الطبقة العاملة الفرنسية، حوالي عشرة ملايين شخص، بما في ذلك أحفاد المهاجرين، ينحدر من المغرب العربي منذ عدة أجيال.
الجدل حول الماضي الاستعماري
في الأشهر الأخيرة، كان استعمار الجزائر محور جدل واسع. فمثلا، بعد أن صرح الصحفي جان ميشيل أباثي Apathie، المعروف بمواقفه المعتدلة، بأن "فرنسا ارتكبت مئات من مجازر في الجزائر مشابهة لمجزرة النازيين بحق اليهود في مدينة أورادور سور غلان الفرنسية"، تم تعليقه عن العمل في محطة الراديو RTL، وتعرض للانتقاد الشديد، وطلب منه تقديم اعتذار. ووصف المسؤول في حزب التكتل الوطني جوردان بارديلا Jordan Bardella تصريحاته بأنها ”تزوير بغيض للتاريخ“. ولا يفاجئنا هذا التصريح الصادر عن اليمين المتطرف، الذي لطالما ضم في صفوفه ورثة مؤيدي الجزائر الفرنسية، الذين لم يستطيعوا أبدا تقبل استقلال هذا البلد. وقد نقل زعيمه المؤسس والراحل جيل جان ماري لوبان Jean-Marie Le Pen هذه الكراهية إلى أحفاده، واليوم، يتعزز هؤلاء الرجعيون بانضمام اليمين التابع للجنرال ديغول لخطابهم، على الرغم من أنهم كانوا معارضين له بشأن القضية الجزائرية. فها هم الآن مجتمعون، يعيدون إحياء أسطورة مزايا الجزائر الفرنسية، ويؤججون الكراهية تجاه هذا البلد الذي أصبح كبش فداء. وساركوزي Sarkozi كان قد مهد الطريق بقانونه عام 2005، حيث حاول فرض تدريس الدور ”الإيجابي“ للاستعمار. لم يتم تمرير قانونه، لكن أسطورة ”التوبة“ المزعومة التي تطالب بها الجزائر قد انتشرت. ناهيك عن عدد المرات التي كرر فيها عبارة ”ليس لدينا ما نخجل منه في تاريخ فرنسا“. لقد مهد ساركوزي الطريق لريتايو ودارمانين Darmanin وسيوتي Ciotti، الرئيس السابق لحزب الجمهوريين الذي تخالف مع لوبان، والذي تجرأ على وصف تصريحات أباثي بـ”الإهانة لفرنسا“ و”العار“.
لكن العار الحقيقي الوحيد هو إعدام 800 من سكان بليدة في عام 1830، ومذبحة قرويي زاتشا بعد ذلك بعشرين عاما، حيث عرضت جماجم الضحايا في متحف الإنسان في باريس! والعار هو حبس 500 فرد من قبيلة بني سبيح حتى الموت في كهف واسع في عين مران، بين تلمسان ومستغانمة. والعار هو حرق الناس بالدخان، كما حدث في عام 1845، مما أدى إلى اختناق ألف فرد من أفراد قبيلة لجأت إلى كهوف جبل الدهرة.
الغزو الاستعماري
في عام 1830، شهدت الجزائر وصول القوات الفرنسية والممولين والمستعمرين الذين جاءوا لجمع الثروات ونهب خيرات البلاد. واستغرق الأمر أربعين عاما حتى تمكن الجيش الفرنسي من قمع المقاومة الشرسة للشعب. فضم شمال الجزائر، حيث تم ذبح النخب المحلية في عام 1848، وقسمه إلى ثلاث مقاطعات وحوله إلى مستعمرة استيطانية.
وفي عام 1881، استولت فرنسا على تونس، ثم في عام 1912 على جزء من المغرب، بينما احتلت إسبانيا البقية. وإذا كانت فرنسا قد استخدمت عبء الديون للسيطرة على اقتصادات هذه البلدان، فإنها لجأت أيضا إلى القوة العسكرية. كما استخدمت كل الخبرة التي اكتسبتها في الجزائر في مجال القمع الاستعماري. ففي عام 1910، قمعت القوات الفرنسية انتفاضة شعبية في المغرب بوحشية. وبعد عمليات غزو وجيزة لكنها لم تكن أقل عنفا، وضعت فرنسا تونس والمغرب تحت وصايتها، مدعية أن هذين البلدين غير قادرين على إدارة شؤونهما دون ”مساعدة“. وفي سبيل إدارتهما، اختارت فرنسا الاعتماد على سلطات محلية، أي الباي في تونس والسلطان في الرباط.
وتم تقديم استمرار الاستعمار إلى الشعب الفرنسي دائما على أنه ضروري لعظمة فرنسا وأنه أمر بديهي. وبالنسبة لمليون أوروبي عاشوا في الجزائر لعدة أجيال، كانت ”الجزائر هي فرنسا“ وكان ذلك يبدو أمرا لا رجعة فيه.
صعود الحركات القومية
صحيح أن فرنسا قد واجهت في المغرب العربي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ثورات هزت الإمبراطورية الاستعمارية، لكنها استطاعت في كل مرة إعادة إحلال النظام.
ففي عام 1925، في جبال الريف شمال المغرب، استخدمت فرنسا كل قوة جيشها لسحق الانتفاضة الشعبية بقيادة عبد الكريم الخطابي، الذي لم يكتف بإلحاق هزيمة نكراء بالجيش الإسباني، بل نجح أيضا في إقامة جمهورية الريف التي كان يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، والتي هددت بالامتداد إلى بقية المغرب العربي.
في الوقت نفسه، كانت السلطات الفرنسية تراقب عن كثب الحزب الشيوعي الفرنسي الناشئ، الذي انبثق عن الثورة الروسية. كان هذا الحزب يرفع عاليا راية الأممية، داعيا الجنود الفرنسيين إلى التآخي مع جنود الريف. في عام 1925، استجاب 900 ألف عامل فرنسي لدعوته إلى الإضراب ضد هذه الحرب الاستعمارية القذرة التي شنها بيتان Petain.
|
 |
|
في كل مكان، كان قمع الدول المستعمرة وازدراءها يعززان الشعور بالاضطهاد الوطني. من الرباط إلى تونس، نشأت أجيال جديدة من النشطاء ونظمت نفسها.
في عام 1924 في باريس، سعت الرابطة المشتركة بين المستعمرات، التي أنشأها الحزب الشيوعي، إلى مخاطبة جميع المضطهدين في المستعمرات، دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم. كما تجمع العمال الجزائريون في نجمة شمال إفريقيا للمطالبة بالاستقلال وكذلك على وحدة بلدان المغرب العربي الثلاثة. ورغم أن الشرطة اعتقلت زعيمها مصالي الحاج مرات عديدة، اكتسبت نجمة شمال إفريقيا نفوذا في فرنسا والجزائر.
وفي أوائل الثلاثينيات، في المغرب، كان ”الشباب المغاربة“، المنتمون إلى الطبقات التقليدية الميسورة، هم من بادروا إلى التحرك. بينما في تونس، أسس محام شاب يدعى بورقيبة حزب "الدستور الجديد".
لكن في ثلاثينيات القرن الماضي، وبينما كان العالم يهتز بسبب أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جاءت أكثر الاحتجاجات تصميما من قبل الطبقة العاملة، وبلغت ذروتها بالإضراب العام في مايو ويونيو عام 1936.
وقد بدأت هذه الاحتجاجات في فرنسا، ثم اجتاحت المغرب العربي. ومع وصول حكومة الجبهة الشعبية اليسارية للسلطة في فرنسا عام 1936، بدا الاستقلال ممكنا.
في تونس، أدى تصميم العمال الفرنسيين والتونسيين ووحدتهم إلى فرض تطبيق ما اكتسبه العمال في فرنسا عبر الاضرابات، على العمال التونسيين. وكان هذا الاتحاد بمثابة تأكيد على أن الطبقة العاملة يمكن أن تكون قوة قادرة على قيادة ثورة جميع المضطهدين من خلال التغلب على الانقسامات التي خلقتها الدولة الاستعمارية.
أما في المغرب والجزائر، كان الرد الوحيد من قبل اليسار الحاكم هو القمع. فانتشرت خيبة الأمل والغضب بين عمال هذين البلدين فتوجهوا إلى المنظمات الوطنية. وكرمز على ذلك، تخلى مصالي الحاج عن العلم الأحمر ليصنع علما جزائريا.
وهكذا تمكنت البرجوازية الفرنسية من الاعتماد على ليون بلوم Léon Blum من الحزب الاشتراكي لإنقاذ نظامها الاجتماعي والاستعماري، ولكن أيضا على الحزب الشيوعي الذي أدار ظهره نهائيا للسياسة الأممية التي كان ينتهجها في بداياته.
لقد تم إنقاذ النظام الاستعماري، لكن زمنه كان قد بدأ ينفد.
بعد الحرب العالمية الثانية
قوضت الحرب العالمية الثانية بشكل نهائي أسس الإمبراطورية الاستعمارية. لكن فرنسا، بقيادة الجنرال ديغول، تشبثت بها أكثر فأكثر لأنها كانت قد خرجت ضعيفة من هذا الصراع العالمي الذي كان الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية المنتصرين الكبيرين فيه. لم يتمكن ديغول من تجنب اندلاع الثورات التي كانت تختمر، والتي كان يغذيها الفقر المدقع وتصاعد المطالب القومية. وكان إنزال قوات الحلفاء في نوفمبر 1942 واللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي روزفلت وسلطان المغرب في الدار البيضاء حافزا للمناضلين المغاربة لإنشاء حزب جديد سمي حزب الاستقلال.
انطلقت شرارة الثورة الأولى في الجزائر، في منطقة القسطنطينية، في 8 مايو 1945، أي قبل 80 سنة من الآن. وفي المسيرات التي نظمت بمناسبة تحرير فرنسا من النازية، هتف المناضلون الجزائريون ”يسقط الاستعمار“، فهاجمت الشرطة المتظاهرين وهم كانوا يرفعون العلم الجزائري الجديد. وفي ولاية سطيف، تحولت المسيرة إلى مواجهة امتدت على مدار اليوم التالي، مما أثار بدوره حملة قمع شرسة خلفت ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قتيل. وقد منحت هذه المذبحة التي نفذت بتواطؤ من الوزراء الشيوعيين مهلة لمؤيدي الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
كانت هذه السنوات التي تلت الحرب، بالإضافة إلى سنوات الحرب، سنوات رهيبة حيث تم توجيه جميع موارد المستعمرات إلى فرنسا كأولوية مثل القمح والشعير، الأمر الذي وضع سكان المستعمرات في حالة مجاعة.
|
 |
|
 |
في المغرب وتونس، شهدت سنوات ما بعد الحرب تصاعدا في الإضرابات العمالية، ذلك مع أن الحزب الشيوعي الفرنسي كان يعارض قيام الاضرابات، فهو كان يخوض حينها "معركة زيادة الإنتاج" في فرنسا، على حساب العمال.
في المغرب، انضم العمال المناضلون إلى حزب الاستقلال. وكان يقود هذا الحزب الجديد آنذاك علال الفاسي الذي قد أنشأ نقابات سرية مناضلة. وعززت الإضرابات الناجحة التي اندلعت في عام 1951 من قوة الحزب. كما حاول السلطان الاستفادة من هذه النجاحات في عام 1952، عندما طالب أمام حشد جماهيري ضخم بـ«التحرر السياسي الكامل للمغرب».
في تونس، كان الزعيم النقابي فرحات حشاد قد انفصل عن الاتحاد العام للعمال التونسيين (CGT) ليؤسس في عام 1946 الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT). ففي الواقع، وبالتوافق مع الـCGT الفرنسية، التي كانت متوافقة مع الحكومة الفرنسية، كانت الـCGT التونسية تقدم الإضراب على أنه «سلاح الشركات الكبرى» وتحث العمال التونسيين على إعادة بناء البلد الذي يضطهدهم مهما كان الثمن.
وشهد الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة فرحات حشاد ازدهارا سريعا: ففي غضون عامين من تأسيسه، بلغ عدد أعضائه 100 ألف عضو. كان فرحات حشاد قد رفض الـCGT بقيادة فراشون التي كانت تسخر قوة العمال في سبيل خدمة البرجوازية الفرنسية. لكن من خلال دعمه لحزب الدستور الجديد بقيادة بورقيبة، وهو حزب قومي برجوازي، وضع الاتحاد العام التونسي للشغل قوة العمال في خدمة البرجوازية التونسية.
 |
 |
كما أدى اغتيال الزعيم النقابي التونسي إلى اندلاع مظاهرات وإضرابات في المغرب. ثم اتخذت هذه المظاهرات طابعا عنيفا في عام 1953 حين أطاحت السلطات الفرنسية بالسلطان بن يوسف ونفته إلى مدغشقر.
وفي الجزائر، كان من المفترض أن يمنح قانون جديد اعتمد في عام 1947 حق الاقتراع العام للجزائريين، لكن الاقتراع لم يكن عاما إلا بالاسم. إذ لم يقتصر الأمر على إقصاء النساء وحسب، بل أنشأ القانون مجموعتين انتخابيتين ليجعل صوت الفرنسي الواحد يساوي أصوات تسعة جزائريين! أدت هذا الإهانة الجديدة، التي أعقبتها هزيمة الجيش الفرنسي في الهند الصينية، إلى تشجيع جيل جديد من النشطاء على الانخراط في الكفاح المسلح. في 1 نوفمبر 1954، نشأت جبهة التحرير الوطني (FLN) من صفوف حزب مصالي الحاج، لكنه انفصل عن الزعيم القديم. وأطلق قادة الجبهة إشارة بدء الكفاح المسلح من خلال سلسلة من التفجيرات في أنحاء الجزائر.
كان القادة الفرنسيون يخشون من أن تتحد حركات التحرر في بلدان المغرب العربي الثلاثة. كما كانوا يخشون من أن تزداد راديكالية الحركات الثورية في تونس والمغرب وأن تخرج عن سيطرة القوى القومية الأكثر اعتدالا. وقد تأكدت هذه المخاوف إذ اندلعت حرب مسلحة في المغرب وتونس لأيضا.
 |
|||
|
|||
كانت الحكومة الفرنسية تدرك أنها غير قادرة على مواجهة انفجار شامل في جميع أنحاء المغرب العربي، لذا سارعت إلى البحث عن حل لإخماد الحريق. كان بورقيبة في تونس والسلطان في المغرب شريكين مسؤولين يمكن التفاوض معهما. فتم إعادتهما من المنفى، وعند وصولهما إلى البلاد، استقبلهما حشد من الجماهير المبتهجة.
في المغرب، في 2 مارس 1956، تمت إعادة السلطان إلى العرش، واستبدل لقب السلطان بلقب ملك المغرب تحت اسم محمد الخامس. وبعدها ببضعة أيام، في 20 مارس 1956، تولى الحبيب بورقيبة، زعيم حزب الدستور الجديد، رئاسة الحكومة الانتقالية في تونس.
وبعد استقلال تونس والمغرب، صارت أيدي الجيش الفرنسي طليقة لمحاولة إعادة سيطرة النظام الاستعماري على الجزائر. لكن انتهاكاته زادت من صلابة صفوف جبهة التحرير الوطني التي فرضت نفسها على الشعب الجزائري كقيادة للنضال، كما فرضت نفسها على المنظمات المنافسة وأمرتها بالانضمام إليها وإلا تعرضت للمحاربة ولتصفية أتباعها. وبالرغم من قيام القيادة العسكرية الفرنسية، التي أرادت الانتقام لهزيمتها في ديان بين فو Diên Bên Phu في الهند الصينية، بحشد جيشها وقوتها النارية وأكثر من مليوني مجند شاب، لكن الشعب الجزائري تمكن، في 5 يوليو 1962، أي بعد ثماني سنوات من حرب رهيبة، من انتزاع استقلاله.
ثورة شعوب المغرب العربي فتحت آفاقا جديدة... لكنها أهدرت
كلف طرد القوة الاستعمارية الشعب الجزائري ثمنا باهظا: 500 ألف قتيل ومليوني نازح في المخيمات... وكانت عزلة الشعب الجزائري سببا في زيادة حجم التضحيات غير المسبوقة التي قدمها في كفاحه. لكن هذا العزل لم يكن محتما، بل كان نتيجة سياسة القادة القوميين والخيانة المشينة للمنظمات العمالية في فرنسا، والتي تورطت في مذبحة الجزائريين. في المقام الأول، الحزب الاشتراكي الذي ترأس الحكومات التي شنت هذه الحرب القذرة.
أما الحزب الشيوعي، فلم يختلف كثيرا عن الحزب الاشتراكي. فهو قد صوت لمصلحة منح "السلطات المدنية والعسكرية الكاملة" للجيش الفرنسي في الجزائر، الأمر الذي سمح له بإرساء القمع. وفي الوقت الذي كان يدعو فيه إلى السلام في الجزائر، تخلى الحزب الشيوعي الفرنسي عن الشباب المجندين الذين رفضوا في عام 1956 ركوب القطارات التي كانت تقلهم إلى الحرب، تاركا إياهم لمصيرهم. وأدت هذه السياسة إلى تشويه سمعة الحزب الشيوعي الجزائري المرتبط به، وعززت قوة القوميين في جبهة التحرير الوطني.
وفي فرنسا، لم يحتج الحزب الشيوعي الفرنسي عندما تم فرض حظر التجول على عشرات الآلاف من الجزائريين في المدن الفرنسية. ذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى من الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا كانوا عمالا مستغلين، إلى جانب العمال الفرنسيين، في نفس المصانع والمناجم ومواقع البناء والمزارع. لا جبهة التحرير الوطني الجزائرية ولا الحزب الشيوعي الفرنسي ولا أي حزب كبير كان لديه سياسة تدعو هاتين الفئتين من الطبقة العاملة إلى الكفاح معا من أجل أهداف مشتركة، سواء في فرنسا أو على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط. هذا الاصطفاف على كلا الجانبين، كل واحد وراء برجوازيته، لم تنته عواقبه بعد، وما زلنا ندفع ثمنه بعد 60 عاما!
|
 |
بيد أن هذه الفكرة كانت فكرة الأمير عبد الكريم، بطل ثورة الريف، الذي قال: "لو كان هناك، في الجزائر وتونس، وفي نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورة الريف، مقاومة مماثلة، لكانت كتب التاريخ بشكل مختلف". كما كان عمال المستعمرات الثلاث منظمين في "نجمة شمال إفريقيا" لمصالي الحاج، الذي كان يرى في بداياته أن تحرير جميع شعوب المغرب العربي هدف مشترك. وعندما نجح عبد الكريم، الذي هرب من منفاه ولجأ إلى القاهرة، في جمع القوميين الجزائريين والمغاربة والتونسيين في أول مؤتمر للمغرب العربي في عام 1947، كان لا يزال يدافع عن فكرة مغرب موحد ومستقل.
لكن في الخمسينيات، أدار القادة القوميون في البلدان الثلاثة ظهورهم للرؤية التي رسمها عبد الكريم. لذا، لم يكن من البديهي أبدا أن يؤدي رحيل فرنسا إلى ظهور ثلاث دول متعارضة ومتنافسة!
ومع ذلك، في زمن الاستقلال، جسدت هذه الدول الجديدة في عيون شعوبها نهاية الازدراء واستعادة الكرامة. وكان بالفعل بإمكان الشعوب أن تشعر بالسعادة والفخر بإنهاء الإذلال الاستعماري. ولكن إذا كانت هذه الشعوب تتوق من كل قلبها إلى انتشال بلدانها من التخلف، فإن أملها سرعان ما تلاشى ليحل محله الإحباط.
ورغم أن هذه الأنظمة كانت تستند إلى أيديولوجيات مختلفة، إلا أنها سرعان ما اتخذت الشكل نفسه في كل بلد، وهو شكل النظام الاستبدادي. أما خطاب القادة القوميين حول وحدة المغرب العربي، فلم يمر وقت طويل حتى اكتشفت الشعوب أنه مجرد دعاية.
وقد صرح محمد بن بلا، أول رئيس للجمهورية الجزائرية، قائلا: ”إن الوحدة مع أشقائنا في شمال إفريقيا ليست ضرورية فحسب، بل هي أمر حيوي!" لكن كل من هؤلاء القادة أراد أن يكون له جهاز دولته الخاص، وذلك للدفاع عن مصالح برجوازيته ضد جيرانها وضد شعبها. كل واحد أراد أن يكون سيد أرضه، خلف حدوده، ليحصل على أفضل حصة من الفتات الذي خلفته الإمبريالية. في حين أن الوحدة أو حتى مجرد التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث كان من شأنه أن يمنحهم إمكانيات أكبر لمقاومة الضغوط الإمبريالية، لا سيما ضغوط القوة الاستعمارية السابقة.
وعند استقلال الجزائر، أدت هذه الخصومات إلى صراعات بين الأشقاء حول ترسيم الحدود.
فالملكية المغربية طالبت، باسم ”المغرب التاريخي“ ما قبل الاستعمار، بأراض تمتد حتى الحدود مع مالي والسنغال، بما في ذلك الصحراء الإسبانية وموريتانيا وجزء من الصحراء الجزائرية. في حين رفضت جبهة التحرير الوطني الجزائرية المطالب المغربية، بحجة عدم قابلية الحدود المستمدة من الاستعمار للتغيير. واعتبرت أن الشعب الجزائري دفع ثمن هذه الأراضي بدمائه. وفي خريف عام 1963، بعد عام من استقلال الجزائر، تلاشت أحلام الوحدة المغاربية نهائيا عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيوش المغربية والجزائرية للسيطرة على مدينتي تنجوب وحسي بيدا، على حدود الصحراء. وقد أسفرت ”حرب الرمال“ هذه عن مقتل أكثر من ألف شخص. وبعد ثلاث سنوات، طالب التونسي بورقيبة بدوره بمنطقة حدودية أطلق عليها اسم ”الحدود 233“، لكنه تراجع عن تصعيد الخلاف مع جارته الجزائر.
كانت هذه النزاعات الحدودية، في مناطق صحراوية غنية بالمعادن والهيدروكربونات، تعكس الحاجة الملحة للطبقات الحاكمة الجديدة في هذه الدول إلى الاستيلاء على الموارد التي يمكن أن تنمي اقتصاداتها الناشئة، في عالم تهيمن عليه الإمبريالية.
كان اقتصاد هذه البلدان، الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، قد تشوه بسبب الاستعمار الذي كان يهدف في المقام الأول إلى تلبية احتياجات فرنسا. في البلدان الثلاثة، أبدى القادة رغبتهم في تنمية بلادهم وقدمت الإصلاحات الزراعية كحل لتوفير الغذاء للسكان المتزايد عددهم، لكن هذه الاصلاحات لم تحقق ما وعدت به.
فالاستقلال السياسي في حد ذاته لم يكن كافيا للخروج من براثن الإمبريالية. إذ أن استغلال الفلاحين والعمال سمح بظهور برجوازية وبرجوازية صغيرة وطنية، وسمح للشركات الكبرى بتحصيل جزيتها. كما قام القادة الجدد ببناء أجهزة قمعية رهيبة كانت مهمتها الأولى قمع الثورات التي اندلعت مرارا وتكرارا.
في الجزائر
في الجزائر، اتخذ النظام الجزائري اسم الجماهيرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مدعيا بذلك أنه يستجيب لمطالب الشعب. في عام 1960، عبر أحد قادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني) عن هذه التطلعات بالقول: ”العمال الجزائريون لا يقاتلون فقط من أجل الحصول على علم وسفارات؛ إنهم يقاتلون من أجل ضمان الأرض للفلاحين والعمل للعمال وظروف معيشية أفضل“.
كان القادة القوميون في جبهة التحرير الوطني يحملون آمال شعب بأكمله في التخلص أخيرا من الفقر. لكن فور الاستقلال، تواجد الشعب، الذي لم يكن له أي سلطة قرار تذكر، أمام مشهد النزاع على الحكم بين قادة جبهة التحرير الوطني. إذ أقام أحمد بن بيلا، المدعوم من الجيش، بإحلال نظام الحزب الواحد وقضى على منافسيه، قبل أن يتم الإطاحة به هو نفسه في عام 1965 بانقلاب عسكري بقيادة بومدين. كانت البرجوازية الجزائرية أضعف من أن تتمكن من حكم البلاد بدون دعم الجيش الذي أصبح العمود الفقري للنظام. وقامت الأجهزة الأمنية العسكرية القوية، التي بنيت خلال حرب الاستقلال، بتطهير جميع الأجهزة التي كان من الممكن أن يتم التعبير فيها عن معارضة للنظام، على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وكرست اتفاقيات إيفيان، الموقعة بين فرنسا والجزائر في عام 1962، توازن القوى القائم بين البلدين ووضعت قواعد العلاقات بينهما. وسمحت هذه الاتفاقيات لفرنسا بالاحتفاظ بقواعد عسكرية، بما في ذلك قواعد تجارب نووية في الصحراء. ونجحت البرجوازية الفرنسية في فرض سيطرتها على الهيدروكربونات والثروات المعدنية. من عام 1966 إلى عام 1970، كان 75٪ من إنتاج شركة النفط الفرنسية Elf يأتي من الصحراء.
فاضطرت الدولة الجزائرية إلى الدخول في صراع منذ نشأتها لضمان الحد الأدنى من السيطرة على اقتصادها. بين عامي 1963 و1968، أممت الدولة مليون هكتار من الأراضي المملوكة من قبل المستعمرين والشركات التعدينية و77 مصنعا فرنسيا خاصا. وفي 20 يوليو 1970، حاولت الدولة الجزائرية فرض زيادة على الشركات الفرنسية في سعر برميل النفط من 2 دولار إلى 2،80 دولار. رفضت فرنسا رفع الأسعار ودفع 25 مليار فرنك من الضرائب المستحقة للحكومة الجزائرية. فرد بومديان بتأميم الغاز والنفط، والاستيلاء على 51% من أصول شركات النفط الفرنسية. فأنشأ شركة سوناطراك، وهي الشركة الوطنية المسؤولة عن استغلال النفط والغاز، وأطلق خطة لتصنيع البلاد. وجاء رد الدولة الفرنسية بفرض حظر على صادرات النفط.
|
 |
بالرغم من غياب الحريات، اعتبر الشعب كل هذه الإجراءات انتقاما من التنازلات التي فرضها الإمبريالية الفرنسية في اتفاقيات إيفيان. هذه الإجراءات، التي لم تكن اشتراكية بأي شكل من الأشكال، بل كانت رد فعل دولة برجوازية في بلد فقير، في محاولة لحماية نفسها، إلى حد ما، من الضغط الإمبريالي.
ومع اندلاع أزمة النفط في عام 1973، ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير، مما أدى إلى تدفق العملات الأجنبية إلى الجزائر. فحسنت هذه الوفرة حياة الطبقات الشعبية إلى حد ما، لكن الجزء الأكبر منها استخدم في بناء مجمعات صناعية ومصانع للصلب والبتروكيماويات.
كانت هذه المشاريع تسمى ”اشتراكية“، لكنها في الواقع قد زادت من اعتماد البلاد على الإمبريالية اقتصاديا. ففي سبيل تنمية الصناعة وتشغيل المصانع القائمة، واستيراد الآلات وقطع الغيار باهظة الثمن، اضطرت الجزائر إلى الاقتراض من البنوك الفرنسية. علاوة على ذلك، إن الأموال المخصصة للتنمية الصناعية حرمت الزراعة من الموارد اللازمة لتنميتها، مما دفع الفلاحين إلى الهجرة.
فالجزائر، التي كانت تنتج 70٪ من احتياجاتها الغذائية في عام 1969، لم تعد تنتج سوى 31٪ بعد عشر سنوات. واضطرت إلى زيادة ديونها لاستيراد أطنان من الحبوب ومنتجات الألبان من أوروبا.
وعندما توفي بومدين في 27 ديسمبر 1979، تدفقت حشود غفيرة على الجزائر العاصمة لتكريم الرجل الذي جسد نهاية الإذلال الاستعماري. كان العقيد بومدين قد حكم البلاد بيد من حديد، لكن التقدم الذي أحرزه في مجالي الصحة والتعليم أكسبه شعبية واسعة.
ومن خلال تقديم اللجوء والمساعدة للمعارضين السياسيين من جميع أنحاء العالم، من نشطاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب إفريقيا إلى جماعة البانترز السود، مرورا بالفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، عزز بومدين مكانة الجزائر الدبلوماسية، وعمل على ترويج صورة للنظام على أنه ثوري، لكنه في الواقع لم يكن يتسامح مع أي معارضة في بلده، كما أنه شجع ممارسة الدين. كان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والذي يشكل الإطار الأخلاقي لحياة الجزائريين. وكان تعزيز دوره سياسة متعمدة للنظام، وكان ذلك أيضا نقطة مشتركة بين الأنظمة الثلاثة. وكان ذلك أمرا جليا بالنسبة لمحمد الخامس الذي كان يحمل لقب ”أمير المؤمنين“، لكن بورقيبة فعل الشيء نفسه.
في المغرب
في المغرب، عمل الملك الجديد محمد الخامس منذ الاستقلال على توطيد سلطته بمساعدة فرنسا وجناح حزب الاستقلال القومي الأكثر تحفظا. كان المغرب مستقلا، لكن اقتصاده ظل زراعيا ومتأثرا بالاستعمار. وكانت تطلعات ملايين الفلاحين الفقراء في الريف والطبقات الشعبية في المدن والبرجوازية الصغيرة المثقفة أو التجارية وأصحاب الأعمال الصغيرة أو الكبيرة، وأصحاب الأراضي، متعارضة مع بعضها البعض.
استغل محمد الخامس هذه الانقسامات بمهارة. وهو وإن كان مدينا بسلطته إلى الدولة الفرنسية، إلا أنه قدم نفسه على أنه "شهيد الاستقلال".
وقد منحه حزبه الاستقلال هذا اللقب بحجة أنه عارض الوصاية الفرنسية وقد تم نفيه لمدة ثلاث سنوات. كما أن لقب ”أمير المؤمنين“ منحه شرعية لدى الشعب كما أن كونه وريث السلالة المغربية القديمة منذ ما قبل الاستعمار قد أكسبه ثقة الطبقات المالكة.
وفي سبيل بناء دولة تحت سيطرته، لجأ محمد الخامس إلى المناورات السياسية طارة واستخدام القوة طارة أخرى. وأشرك حزب الاستقلال في السلطة، ما أدى إلى انقسام الحزب الذي كان يضم قوى ذات مصالح متضاربة.
وفي الصحراء الإسبانية، ترك محمد الخامس القوات الفرنسية والإسبانية تسحق مقاتلي جيش التحرير المغربي، الذين كانوا يدعمون القوات الصحراوية في نضالها من أجل الاستقلال. وفي الريف، كانت ثورة شعبية، ترفض إلقاء السلاح قبل حصول الجزائر على استقلالها، تضايق الجنود الفرنسيين. في نهاية عام 1958، بعد عامين من الاستقلال، أرسل ولي العهد الحسن الثاني، مدعوما باللواء أوكفير، على رأس 20 ألف رجل لسحق هذا التمرد. وقام بقصف قرى الريف، مما أسفر عن مقتل وجرح عدة آلاف من الأشخاص.
في عام 1961، قبل وفاته المفاجئة، نجح محمد الخامس في تهميش حزب الاستقلال والأحزاب المنبثقة عنه، وفي تشكيل جيش وجهاز قمعي يخضع لسيطرته، بينما كان يتمتع بدعم شعبي. وكسب ابنه الحسن الثاني الذي خلفه على رأس الجهاز القمعي ثقة البرجوازية الفرنسية التي رأت فيه حليفا قويا يضمن مصالحها حتى ضد شعبه. وهكذا بدأت الصداقة الفرنسية المغربية الأسطورية، وأصبح الحسن الثاني يلقب بـ"صديقنا الملك".
|
 |
وجعل دستور عام 1962 الملك ”شخصا مقدسا ومصونا“، والنظام الملكي نظاما إلهيا. وكان الملك أكبر ملاك للأراضي وأغنى رجل في البلاد، على رأس مجموعة صناعية مغربية كبيرة، تسمى أومنيوم، وكانت تستغل مناجم الفوسفات، أهم مورد في البلاد.
وكانت العلاقات الجيدة مع الملكية هي أفضل طريقة، إن لم تكن الوحيدة، للتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وكان شقيق الملك، مولاي عبد الله، وسيطا لا غنى عنه. وكان يلقب بـ ”صاحب السمو 51٪“، لأن هذه هي النسبة التي كان يطالب بها للشركات المغربية والأجنبية التي كان يرعاها. وبينما كانت هذه الشركات تزدهر في ظل دكتاتورية الحسن الثاني، كانت الطبقات الشعبية تعيش في فقر مدقع.
في عام 1965، نزل طلاب المدارس الثانوية في الدار البيضاء إلى الشوارع وانضم إليهم سكان الأحياء الفقيرة والعاطلون عن العمل والعمال. وامتد التمرد إلى منطقة فاس. أطلقت الشرطة النار. وقام رئيس الأمن المغربي، الجنرال أوكفير، جلاد الريف، بإطلاق النار بنفسه على الحشود من طائرة هليكوبتر. وتم حشد الدبابات في المدينة. وعلى مدى ثلاثة أيام، قتل النظام مئات الشباب والفقراء. كما أعلن الحسن الثاني حالة الطوارئ التي استمرت خمس سنوات.
أدى قمع الدار البيضاء إلى بدء ما عرف بـ«سنوات الرصاص»، التي استمرت طوال الثلاثين عاما من حكم الحسن الثاني. أصبح الجنرال أوكفير وزيرا للداخلية وكلف بالقضاء على كل أشكال المعارضة. ولا يمكن إحصاء عدد ضحاياه الذين كان من بينهم مهدي بن بركة، أحد قادة حزب الاستقلال السابقين قبل انضمامه إلى المعارضة، والذي اغتاله أوكفير عام 1965 بمساعدة المخابرات الفرنسية. وهناك شهادات عديدة عن مشاهد لا تطاق من التعذيب الذي تعرض له
 |
||||
|
||||
المعارضون السياسيون أو من يشتبه في أنهم كذلك. ويعد سجن تزمامارت، في جبال الأطلس المغربي، حيث عانوا لسنوات من أسوأ أنواع المعاملة، رمزا لتلك السنوات المظلمة.
وإذا ما تمكنت الملكية من إعادة إحلال النظام، فإنها كانت قد أصبحت هشة. فقد تلاشى الدعم، بل والحماس الشعبي الذي كانت قد حشوده في وقت الاستقلال، وحل محله الاشمئزاز من المحسوبية والفساد. وفي صفوف الأركان العامة، بدأت فكرة التخلص من الملك تتبلور. وفي عامي 1971 و1972، حاول ضباط كبار في الجيش، من بينهم الدموي أوكفير، اغتياله دون جدوى. وأدت محاولات الانقلاب هذه إلى النيل من هيبة الملك الضعيف. ولإعادة بريقه واستعادة سيطرته على الجيش، قرر الحسن الثاني التحرك.
فقمع بشراسة الضباط الذين تمردوا وسعى للحصول على دعم من اليسار برفع الحظر المفروض على الحزب الشيوعي المغربي.
وفي عام 1975، أتاحت وفاة الجنرال فرانكو، الدكتاتور الإسباني، الفرصة للملك المغربي لضم الصحراء الغربية.
وتحت اسم ”المسيرة الخضراء“، حشد الحسن الثاني 350 ألف رجل وامرأة لاستعادة هذه المستعمرة الإسبانية التي كانت على وشك الاستقلال. وعلى عكس الأسطورة التي صنعتها الحكومة المغربية، لم تكن هذه المسيرة اندفاعا شعبيا عفويا مدفوعا بحماس إلهي.
|
 |
كل شيء كان مدبرا من قبل السلطة على أعلى المستويات. كان على كل مدينة أن ترسل حصتها من ”المتطوعين“، تحت إشراف آلاف الضباط من القوات المسلحة والدرك الملكي. مهدت ”المسيرة الخضراء“ الطريق لاحتلال المغرب العسكري للصحراء الغربية، ودوسا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبعد رحيل القوات الإسبانية في عام 1976، استعاد المغرب شمال ووسط الصحراء الغربية، بما في ذلك عاصمتها العيون، بينما استولت موريتانيا على الجنوب. وأعلنت جبهة البوليساريو، التي تضم القوميين الصحراويين، قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD). وقد اعترفت بها الجزائر على الفور. ثم اندلعت ”حرب الرمال“ الجديدة بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي.
ومنذ ذلك الحين، لم يعد الضباط المنشغلون بمحاربة جبهة البوليساريو يشكلون تهديدا لحسن الثاني. كما أتاحت له الحرب فرصة الحصول على إجماع جميع القوى السياسية في البلاد، من الأحزاب التقليدية إلى الحزب الشيوعي. وتخلى القوميون المغاربة عن خطابهم المناهض للملكية وتوحدوا حول قضية الصحراء الغربية.
فاندلعت حرب شرسة ضد الصحراويين. وبالرغم من القمع، لم يستطع النظام إجبار هذا الشعب على الاستسلام، وبعد خمسين سنة، لا تزال قضية الصحراء الغربية معلقة.
في تونس
في تونس حكم حبيب بورقيبة منذ عام 1956 تحت عنوان ”جمهورية“ ادعت أنها علمانية وحديثة وديمقراطية ومنفتحة على الغرب. وهو كان قد اكتسب شعبيته من خلال السنوات العشر التي قضاها في المنفى أو في السجن، ومن خلال الدعم الذي قدمه له الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اتحاد نقابات عمالية قوي. كانت شعبيته ميزة في عيون الأثرياء التونسيين الحريصين على التمتع بثرواتهم بهدوء، وكذلك في عيون الرأسماليين الأجانب الذين كانوا يعتبرونه ضمانة لأمن استثماراتهم.
على غرار بومدين في الجزائر وحسن الثاني في المغرب، فرض بورقيبة سلطته عن طريق قمع جميع المعارضين بشراسة، وكذلك جميع من كان من داخل حزبه يهدد بمنافسته. وفي عام 1961، أمر بقتل صلاح بن يوسف، رفيقه في الكفاح. تم حظر الحزب الشيوعي التونسي، وكذلك الصحافة اليسارية. كما تم تطهير الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوحيدة، عدة مرات. وبذلك أصبح بورقيبة الحاكم الوحيد للسلطة التنفيذية. كانت الانتخابات تجري بالفعل، لكن جميع الأحزاب الأخرى غير حزبه كانت محظورة.
اتخذ نظامه شكل ديكتاتورية شخصية وبوليسية. كانت هذه الديمقراطية الصورية كافية للقادة الفرنسيين لتأييد أسطورة ”تونس الديمقراطية“ والترويج لمزايا الرجل الذي أطلق على نفسه في السبعينيات لقب ”رئيس مدى الحياة“.
وفي عام 1964، وتحت ضغط الولايات المتحدة التي وسعت نفوذها على البلدان التي حصلت على استقلالها، شرعت تونس في إصلاح زراعي يهدف إلى توسيع زراعة المحاصيل التصديرية. وكان التخطيط الزراعي، الذي وصف بـ”الاشتراكي“، الذي وضعته السلطات العليا بمساعدة الجيش والشرطة، يهدف إلى تركيز ملكية الأراضي في أيدي الفلاحين الأغنياء والبرجوازية. وقد قاوم الفلاحون الفقراء، خوفا من فقدان سبل عيشهم، هذه الإصلاحات بشدة. فقد خربوا الإنتاج وذبحوا الماشية، بل ولجأوا أحيانا إلى الإرهاب. وفي عام 1969، في مواجهة انتشار أعمال الشغب الفلاحية، أوقف بورقيبة هذه التجربة، بموافقة الولايات المتحدة.
في عام 1972، سنت قوانين منحت تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في تونس. فاستفادت من ذلك الشركات الفرنسية، وكذلك البرجوازية المحلية الكبيرة والصغيرة. لكن ما كان يهم القوى الإمبريالية هو استغلال مناجم الفوسفات، الضرورية لإنتاج الأسمدة.
الاعتماد الاقتصادي والمديونية وإفلاس الدول
في جميع أنحاء المغرب العربي، كما في العديد من البلدان الفقيرة الأخرى في العالم في نفس الفترة، كانت الزراعة عاجزة عن إطعام عدد متزايد من السكان. في المناطق الريفية، كان الشباب العاطلون عن العمل محكوم عليهم بالهجرة إلى المدن أو إلى أوروبا. ظهرت أحياء فقيرة ضخمة حول الدار البيضاء وتونس والجزائر. لم تؤد أزمة الزراعة هذه إلا إلى تفاقم تبعية بلدان المغرب العربي للإمبريالية. فللتمكن من إطعام شعوبها، اضطرت هذه البلدان إلى استيراد الحبوب والسكر والحليب من البلدان الإمبريالية، ودفع ثمنها بالعملة الأجنبية. ولم يؤد ذلك إلا إلى تفاقم عجز ميزانها التجاري.
وهكذا، في نهاية السبعينيات، شكلت الواردات الغذائية 25٪ من العجز في تونس، وكانت فرنسا المورد الأول لها.
في الجزائر، كانت صادرات الهيدروكربونات المورد الأول للبلاد، بينما في المغرب وتونس، احتلت مبيعات الفوسفات هذا المكان، متقدمة بفارق كبير على المحاصيل التصديرية والسياحة.
لذلك، عندما انهار سعر الفوسفات في عام 1977، وانخفض سعر برميل النفط إلى أربعة أضعاف في عام 1984، كانت الكارثة. على شفا الإفلاس، لم يكن أمام هذه الدول من حل سوى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض على الأنظمة في المقابل فرض خطط تقشف صارمة على العمال والطبقات الشعبية. وأثار ذلك ردود فعل. على مدى عقد من الزمن، كانت منطقة المغرب العربي مسرحا لثورات قادها الشباب.
من إضرابات العمال في تونس عام 1978 إلى أعمال الشغب في أكتوبر 1988 في الجزائر، مرورا بأعمال الشغب التي اندلعت في المغرب عام 1981 بسبب ارتفاع أسعار الخبز، فقد رفعت الشعوب رؤوسها.
|
في تونس
في تونس، في 26 يناير 1978، أمر رئيس جهاز الأمن، المدعو بن علي، الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين الذين استجابوا لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. وحكم على حبيب أشور، زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم صلته بالسلطة، بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة. لكن الاضطرابات العمالية لم تتوقف عند هذا الحد. ففي عام 1980، تسبب الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار السلع الأساسية في اشتعال الأوضاع في حوض قفصة المنجمي، الواقع في منطقة فقيرة في جنوب البلاد. بعد ستة أشهر من الإضراب، استولى عمال المناجم الغاضبون والمسلحون على مدينة قفصة المنجمية، وحظوا بتعاطف ودعم باقي العمال. برر بورقيبة القمع بوصف عمال المناجم بأنهم مغاوير جاءوا من الخارج، ووصف أفعالهم بأنها أعمال حربية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقد رددت الإمبريالية الفرنسية، حرصا منها على إمدادات الفوسفات، حملة التشويه هذه، وأرسلت إلى بورقيبة مساعدات عسكرية وأرسلت ثلاث سفن حربية إلى المياه الإقليمية التونسية.
بعد هذا القمع، قرر بورقيبة فتح الباب أمام الانفتاح السياسي. فتم السماح للأحزاب المحظورة حتى ذلك الحين، مثل الحزب الشيوعي التونسي، بالعمل. كانت السلطة بحاجة إلى دعم النقابات لإضفاء مظهر من الشرعية على هذه الديمقراطية المزعومة. فتم الإفراج عن قادة الاتحاد العام التونسي للشغل من السجن لكي يبرموا اتفاقا انتخابيا مع حزب بورقيبة الذي قمعهم! وقدموا مرشحين مشتركين تحت عنوان ”الجبهة الوطنية“! إذ أيد الاتحاد العام التونسي للشغل الديمقراطية على طريقة بورقيبة. وتمكن مرشحون آخرون من التعبير عن آرائهم وتنظيم اجتماعات أثارت اهتمام الشعب. لكن النظام، الذي كان قلقا من نتائج الانتخابات، قام بتزويرها!
وفي يناير 1984، أدت مضاعفة سعر الخبز والسميد إلى تجويع الفقراء، لا سيما في جنوب البلاد حيث كان الخبز يمثل 3/4 من نفقات الغذاء.
وأمام أعمال الشغب التي هزت معظم مدن البلاد، تخلت السلطة عن الزيادات. لأول مرة منذ الاستقلال، أجبر العمال والطبقات الشعبية نظام بورقيبة على التراجع.
في عام 1987، أطاح رئيس الوزراء بن علي ببورقيبة الذي حكم بيد من حديد لما يقرب من ثلاثين عاما. وقام بن علي بتعزيز الرقابة البوليسية، وبحلول مطلع عام 2000، تضاعف عدد أفراد الشرطة أربع مرات، وارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للتنصت من 200 إلى أكثر من 3000 شخص.
وفي الوقت الذي كان فيه العديد من الشباب عاطلين عن العمل، كان الأغنياء يتباهون بثرواتهم، بدءا من عائلة بن علي، التي كانت بمثابة مافيا استولت على الأنشطة الأكثر ربحا في البلاد.
في الجزائر
في الجزائر، تولى الجيش خلافة بومدين بعد وفاته في عام 1978، واختار شادلي بن جيد، الضابط الأقدم في الرتبة الأعلى. بدأت فترة حكمه بثورة وانتهت بنفس الطريقة. إذ اندلعت الأولى في عام 1980 في منطقة القبائل، التي كانت تعتبر نفسها مهمشة ولغتها البربرية ممحوة من الهوية الجزائرية. وبعد قمع أسفر عن مقتل 130 شخصا واعتقال عدد كبير من النشطاء المدافعين عن الثقافة البربرية، اختار النظام الاعتماد على الإسلاميين ضد النشطاء اليساريين الذين كانوا حاضرين بقوة في الجامعات. وسمحت لهم شبكة المساجد الواسعة التي بنتها الدولة أو الشخصيات البارزة بتوسيع نفوذهم على كامل الأراضي.
في عام 1979، أطاحت الثورة الشعبية في إيران بنظام الشاه وأوصلت علماء الدين إلى السلطة. أدى نجاح الإسلاميين المتشددين في إيران إلى تعزيز قوة الإسلاميين في جميع أنحاء العالم.
في الجزائر، تحت ضغطهم، تم سن قانون جديد للأسرة في عام 1984 حيث حكم على النساء بأن يظلن قاصرات مدى الحياة.
لكن في عام 1985، مع انخفاض أسعار النفط، انهارت عائدات البلاد، مما أدى إلى توقف الواردات ونقص السلع الأساسية وانتشار البطالة.
فأدى ذلك إلى اندلاع انتفاضة 5 أكتوبر 1988 التي امتدت إلى المدن الكبرى. بعد 25 عاما من استقلال البلاد، أصبح الشعب يمقت جبهة التحرير الوطني. تم إعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش دباباته. وبعد أسبوع من القمع الدموي، أصبحت مئات الأسر في حالة حداد. وبات الآلاف يبحثون عن أبناء أو إخوة مفقودين أو معتقلين أو معذبين في سجون جنوب الجزائر.
بعد هذا القمع، وفي محاولة لإحياء أنفاس هذا النظام البالي، حاول الجيش فتح الباب أمام الديمقراطية في عام 1989. فتكاثرت الصحف وأعيد السماح بالأحزاب السياسية المحظورة. وقد أدى ذلك إلى بزوغ آمال جديدة وهبت رياح الحرية على البلاد. لكن لم يكن هناك أي حزب قادر على إعطائها طابعا طبقيا ومنظورا ثوريا، وأكثر من استفاد من ذلك هم إسلاميو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذين ازدهروا في ظل السلطة. كانوا على وشك الوصول إلى السلطة بفضل النتيجة الساحقة التي حققوها في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. لكن الجيش، الذي رفض وصول قوة سياسية لا يسيطر عليها إلى السلطة، أوقف العملية الانتخابية. وبعد ثلاث سنوات من التواري عن الأنظار، عاد الجيش إلى الواجهة.
أدى وقف الانتخابات إلى اندلاع حرب بين الجماعات المسلحة الإسلامية من جهة والجيش من جهة أخرى، ووقع السكان في مرمى النيران بين الطرفين. من الجانبين، انخرطت الجماعات المسلحة في حملة إرهاب كان المدنيون ضحاياها الرئيسيين.
لم تكن ما سميت بفترة ”العقد الأسود“ في التسعينيات حربا أهلية، بل حربا ضد المدنيين راح ضحيتها ما بين مائة ومئتي ألف قتيل. لكن الأمر لم يمنعها من أن تكون فترة ازدهار للشركات الدولية الكبرى والبرجوازية الجزائرية التي استطاعت أن تجني أرباحا طائلة. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، فإن التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين لم يتوقف أبدا.
|
وفي عام 1998، أنهت القيادة العسكرية المواجهات بإبرام اتفاق مع الجماعات الإسلامية. بعد ذلك، اختار الجنرالات التواري عن الأنظار مرة أخرى والاختباء وراء واجهة مدنية، ممثلة في زعيم تاريخي للجبهة الوطنية لتحرير الجزائر، بوتفليقة. تحت ذريعة المصالحة، تم العفو عن جرائم العقد الأسود. اليوم، بعد 25 عاما على نهاية هذه المأساة، لا تزال العائلات تبحث عن المفقودين في تلك الفترة.
في المغرب
في المغرب، فرض صندوق النقد الدولي تدابير تقشفية في الثمانينيات في بلد يعاني من التفاوتات الاجتماعية. فقد انتقلت ملايين الهكتارات من الأراضي الاستعمارية، التي تعد من أغنى أراضي البلاد، إلى أيدي النبلاء الريفيين ومسؤولي النظام وبعض الضباط، تاركين وراءهم جماهير الفلاحين في حالة من الفقر المدقع. أما سياسة توطين الملكية الأجنبية، فقد أفادت البرجوازية المغربية الأكثر ثراء، بينما حافظت على رأس المال الأجنبي الذي احتفظ بحصص كبيرة في الشركات. وفي عام 1978، كانت 36 عائلة تسيطر على ثلثي الممتلكات المعنية.
في غضون ذلك، كانت الطبقات الشعبية تخنقها إجراءات التقشف التي أضيفت إلى تكلفة الحرب في الصحراء. كانت هذه الحرب تستنزف 45٪ من ميزانية الدولة! وكان السكان يزدادون فقرا بشكل لا يرحم.
في عام 1981، وفي خضم جفاف شديد، اندلعت ”ثورة الخبز“ في المغرب. في جميع أنحاء البلاد، استهدفت المظاهرات رموز الثراء. أطلقت الشرطة النار على الحشود، مما أسفر عن سقوط ما بين 600 و1000 قتيل، ثلثهم من الأطفال. تم اعتقال الآلاف من الأشخاص وحكم عليهم. وفي عام 1984، وبناء على أوامر من صندوق النقد الدولي، قرر النظام فرض زيادات جديدة على أسعار المواد الغذائية.
في الدار البيضاء، أدى ارتفاع رسوم التسجيل في البكالوريا إلى اندلاع حركة طلابية امتدت إلى المدن الكبرى، وأشعل فتيل ثورة الشباب في الأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية، ثم عمت في نهاية المطاف لتضم الشعب برمته. كانت ثورة ضد البطالة والجوع، ولكن أيضا ضد الديكتاتورية.
أمام الاحتجاجات، تراجع الحسن الثاني عن الزيادات المقررة، ثم أرسل دباباته لإطلاق النار على المتظاهرين، ومروحياته لإطلاق الرصاص من المدافع الرشاشة. وفي خطاب مليء بالكراهية، وصف الشباب الذين أجبروه بشجاعة على التراجع بـ ”اللصوص والكسالى“.
حصيلة ثورات الثمانينيات
في الثمانينيات، تمكنت الطبقات الشعبية في المغرب العربي من حشد قواها ضد حكوماتها. لكن المأساة تكمن في عدم وجود أحزاب تمثل مصالحها، مما دفع العديد من القادة إلى استغلال نضال العمال لتحقيق أهداف لا علاقة لها بمصالح طبقاتهم. في تونس، مهد التحالف المشين بين اليسار والنقابات والنظام الطريق أمام الحركة الإسلامية.
في البلدان الثلاثة، وفي مواجهة أنظمة مكروهة، كان الإسلاميون المعارضة الوحيدة التي استطاعت استغلال السخط الشعبي. وقد نجحوا في كسب الأرض في الأحياء الشعبية، بفضل شبكات المساجد ودورهم في العديد من جوانب الحياة الاجتماعية مثل مساعدة الفقراء، الذين كانوا يستمعون إليهم، على عكس الديمقراطيين الذين لم يحاولوا أبدا مخاطبتهم والاستجابة لتطلعاتهم.
طوال سنوات الثورات الشعبية ضد غلاء المعيشة التي شهدت صعود الإسلاميين، واصلت الأنظمة الثلاثة استخدام ورقة القومية لتحويل غضب شعوبها نحو جيرانها.
.
الصحراء الغربية
في المغرب، واصل الحسن الثاني حربه القذرة في الصحراء ضد 500 ألف صحراوي يعيشون على أراضي تبلغ مساحتها نصف مساحة فرنسا. كان الملك يريد أن يضع يده على الثروات المعدنية وحقول الفوسفات في الإقليم التي تعد من أهم حقول الفوسفات في العالم. كما كان حريصا على السيطرة على الساحل الأطلسي الواسع الغني بالأسماك وحقول النفط المحتملة. وبصفته إقطاعيا، أسس مطالبته على أساس علاقات الولاء بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب.
من جانبها، تذرعت الجزائر بقدسية الحدود التي رسمها الاستعمار ودعمت الجمهورية الصحراوية بحجة أنها تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. لكنها كانت في الواقع تطمع هي الأخرى في منفذ بحري على الساحل الأطلسي، كان من شأنه أن يعزز موقعها أمام المغرب.
بين عامي 1975 و1990، شنت جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، حرب عصابات طويلة الأمد ضد الدولة المغربية التي كانت تمنعها من استغلال الصحراء كما تشاء. وكان الحسن الثاني يحظى بدعم الإمبريالية الفرنسية. لا يزال الصحراويون، اللاجئون في المخيمات في الجزائر، يتذكرون القصف الفرنسي في عملية ”لامانتين“Lamantin التي شنت في عام 1977 ضد جبهة البوليساريو.
بمساعدة تقنيين فرنسيين وخبراء إسرائيليين وأمريكيين، وبدعم مالي سعودي، شيد المغرب جدارا رمليا بطول 2720 كيلومترا.
|
وبذلك تم حصر هجمات جبهة البوليساريو في منطقة بعيدة عن أغنى مناطق الصحراء. ومع ذلك، لم يتمكن المغرب، الذي كان على شفا الانهيار الاقتصادي، من هزيمة الانفصاليين.
لذلك، في عام 1991، بعد خمسة عشر عاما من القتال الذي أودى بحياة عشرة آلاف رجل، اضطر الحسن الثاني إلى القبول بوقف إطلاق النار. ووافق على مبدأ إجراء استفتاء على تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه سعى باستمرار للحيلولة دون إجرائه.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انضم 200 ألف مستوطن مغربي إلى الـ 200 ألف جندي الموجودين في الإقليم. وشجعت السلطات العمليات الاستيطانية عبر تقديم مساعدات من مساكن وسلع أساسية بأسعار منخفضة ونقل مجاني وزيادة في رواتب الموظفين. كان الهدف هو تقليل الوزن السكاني للصحراويين وجعل الضم أمرا لا رجعة فيه.
قضية الصحراء، التي قدمت على أنها قضية وطنية ومقدسة، سمحت للنظام الملكي بترويض جميع الأحزاب السياسية. إذ خضع الجميع لهذه القضية، وقمع من لم يذعن لها، على غرار أشهر الناشطين المسجونين في سجون الحسن الثاني، وهو أبراهام سيرفاتي. وكان سيرفاتي، الذي ينحدر من عائلة يهودية مغربية، قد ترك الحزب الشيوعي لتأسيس جماعة ماوية، وأدى انتقاده للملكية ورفضه للحرب الاستعمارية في الصحراء إلى اتهامه بـ"التآمر على أمن الدولة" والحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن القنيطرة الشهير. على الرغم من الإذلال والتعذيب، رفض التراجع عن مواقفه. وبعد الفضيحة التي أثارها نشر كتاب جيل بيرو Gilles Perrault ”صديقنا الملك“، اختلقت له السلطات جنسية برازيلية كحجة لطرده.
عندما توفي الحسن الثاني في عام 1999، ترك لابنه محمد السادس ثروة هائلة. ورث الابن الشركة المغربية الخاصة الأولى وحصصا في العديد من الشركات الأجنبية مثل شركة سيمنز الألمانية. ووفقا لصحيفة لوموند، كان الحسن الثاني ”يمتلك حوالي عشرين حسابا مصرفيا مليئا بالمال، وقصرا في مدينة بيتز Betz في ضواحي باريس، وأكثر من عشرين قصرا مخبأ عن الأنظار، جميعها جاهزة لاستقباله على مدار الساعة“.
كان محمد السادس يعتزم تجسيد تغيير جذري عن سنوات حكم حسن الثاني. فعندما تولى الحكم في سن 33 عاما، أراد أن يظهر بمظهر عصري ومتوافق مع الشباب وقريب من الشعب، وأطلق على نفسه لقب ”ملك الفقراء“!
لكنه سار على خطى والده في قضية الصحراء، حيث سارع عملية استغلال مواردها. وفي خريف عام 2010، تجمع 20 ألف صحراوي في أكديم إزيك (Gdeim Izik) للتنديد بالتهميش الذي يتعرضون له. لم يسمح لأي وسيلة إعلامية بتغطية الحدث، وبعيدا عن الأنظار، طوقت قوات الأمن مخيمهم المكون من 7000 خيمة. وفي فجر 8 نوفمبر، شن الجيش هجوما أسفر عن مقتل 11 جنديا مغربيا و36 صحراويا وخلف مئات الجرحى.
هذه هي حقيقة التنمية المتناغمة في الصحراء التي تروج لها الدعاية الملكية! دعاية رددها السياسيون الفرنسيون دون أي خجل! خاصة منذ ديسمبر 2020.
![]()
الصحراء الغربية والتوترات الإقليمية
في الواقع، في 10 ديسمبر 2020، بعد شهر من استئناف القتال بين البوليساريو والجيش المغربي، أعلن الرئيس دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من نهاية ولايته الأولى، أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكان هذا الاعتراف، الذي جاء في إطار اتفاقات أبراهام التي رعاها ترامب، يهدف، باسم السلام في الشرق الأوسط، إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
كانت صفقة على طريقة ترامب: الاعتراف بالصحراء المغربية مقابل التطبيع مع إسرائيل. في الواقع، كان هذا التطبيع أمرا طبيعيا، نظرا للعلاقات الوثيقة التي لطالما ربطت بين إسرائيل والمغرب.
أدى هذا الإعلان إلى كسر الوضع الراهن وزعزعة التوازن في المنطقة، مما أدى إلى إحياء التوترات بين الجزائر والمغرب. وكشفت الصحافة عن عمليات التنصت الواسعة النطاق التي استهدفت الجزائر من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية عبر عملية ”بيغاسوس“، مما عجل بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي أغسطس 2021، أغلقت الجزائر خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا عبر المغرب، مما حرمها من الوصول إلى الغاز الجزائري.
وبدعم من الولايات المتحدة، دخل المغرب في مواجهة مع جميع الدول التي لا تعترف بالصحراء كجزء لا يتجزأ من أراضيه. في عام 2022، استسلمت إسبانيا للضغوط المغربية، وفي العام 2024، جاء دور إيمانويل ماكرون الذي كان حريصا على حماية مصالح البرجوازية الفرنسية في هذا البلد.
ففي ظل الحرب التجارية المحتدمة وطرد القوات الفرنسية من منطقة الساحل، أصبح من الحيوي بالنسبة للإمبريالية الفرنسية الحفاظ على مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب. لا سيما أنها ترى نفسها مهددة في الجزائر من قبل منافسيها الأتراك والصينيين والإيطاليين بشكل خاص في مقابل هذا الاعتراف، حظي إيمانويل ماكرون، في نهاية أكتوبر، خلال زيارته الرسمية للمغرب، باستقبال فخم، وقبل كل شيء، بوابل من العقود بقيمة 10 مليارات يورو. وكان من بين الوفد الضخم وزراء وشخصيات لطالما حافظوا على علاقات مع المملكة، حيث تتوفر لهم جميع التسهيلات لقضاء عطلاتهم المترفة. أما بالنسبة لرجال الأعمال الموجودين في الوفد، فإنها الطريقة المعتادة للعمل وإعداد الأرضية على أفضل وجه.
لا يمكن حصي عدد الإقامات الخاصة لرجال الأعمال، من بينهم قادة شركات إنجي (Engie) وسافران (Safran) وتوتال إنرجي (Total Energies) وسويز (Suez) وفيوليا (Veolia).
كما تستعد مجموعة ألستوم (Alstom) لإنتاج وتسليم 168 قطارا. وقد أبرمت شركة إيرباص صفقة بيع 15 إلى 18 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال. وتقوم شركة EDF ببناء مشروع طريق سريع كهربائي في شمال الصحراء الغربية، بين الداخلة والدار البيضاء. من جانبها، وقعت شركة توتال إنرجي عقدا بقيمة 2 مليار يورو لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر على الساحل الأطلسي للصحراء.
كل هذه الصفقات السافرة التي تتم في تجاهل لمصالح الشعب الصحراوي هي مثيرة للاشمئزاز!
![]()
يدفع الشعبان المغربي والجزائري ثمنا باهظا للتوترات التي تغذيها حكوماتهما وتؤججها القوى الإمبريالية. فهذه الخصومات ليست من فعل الشعبين، بل من فعل برجوازياتهما التي تتمسك بحدود دولها وتعتمد على أجهزتها الحكومية لحماية نفسها من البرجوازية الأخرى وللدفاع عن مصالحها.
كما أن التنافس والتوترات المستمرة وحالات الحرب الدورية حالت دون تحقيق أي تعاون اقتصادي على مستوى المغرب العربي بأسره.
لقد جرت محاولة جادة للتعاون في عام 1989، عندما كان المغرب العربي يخنقه صندوق النقد الدولي والحرب في الصحراء الغربية تدمر المغرب. في ذلك العام، ألقى الحسن الثاني وشادلي بن جيد السلاح لإعطاء الحياة إلى الاتحاد المغاربي العربي (UMA)، لكن الأمل لم يدم طويلا وبقي هذا الاتحاد مجرد قشرة فارغة.
|
أدى هذا الإغلاق، القائم منذ 30 عاما، إلى قطع الروابط الإنسانية الوثيقة التي كانت تربط بين جانبي الحدود.
ويدفع الشعبان الثمن اقتصاديا من خلال سباق التسلح الذي تخوضه حكوماتهما. وقد بلغ هذا السباق ذروته في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الجزائر أكبر مشتر للأسلحة في أفريقيا، بعد أن أنفقت 24 مليار دولار في عام 2024. ومن المقرر أن تخصص المغرب ميزانية قدرها 13,3 مليار دولار للقوات المسلحة الملكية في عام 2025.
ويبلغ إجمالي مشتريات البلدين أكثر من 60٪ من مشتريات الأسلحة في أفريقيا! إنه هدر فادح! في الوقت الذي تعاني فيه شعوب المغرب العربي من أزمة اجتماعية حادة، وبطالة جماعية، وتضخم شديد، وتدهور الخدمات العامة، يتم إهدار جزء متزايد من الثروة في شراء الأسلحة. ويستغل النظامان المغربي والجزائري هذا التصعيد والمناخ الحربي المصاحب له لإثارة النزعة القومية وإسكات الأصوات المعارضة. فقادة المغرب العربي يدركون أنهم يجلسون على براكين يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
![]()
الثورات ضد النظام: من الربيع العربي إلى الحراك
تونس في عام 2011 وسقوط الديكتاتور
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت الأوضاع تحت سيطرة القادة. في الجزائر، نجح بوتفليقة، الذي بدأ رئاسته بقمع انتفاضة واسعة النطاق في القبائل، في فرض سيطرته مستفيدا من تطلعات الشعب الذي كان يطمح إلى السلام والاستقرار بعد عقد من الفوضى. في المغرب، كان محمد السادس يهدف إلى تجسيد التجديد والقطع عن سنوات الرصاص. كانت تونس، بقيادة بن علي، تعتبر نموذجا للاستقرار، وكان يطلق عليها آنذاك اسم ”المعجزة التونسية“. وكانت اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي قد جعلت من تونس جنة للشركات الفرنسية التي استقرت فيها والبالغ عددها 1200 شركة.
بالنسبة لشركات فوريسيا، فاليو، PSA، رينو، سوسيتيه جنرال، BNP Paribas، دانون، كانت هذه بالفعل معجزة، فقد كانت لديها يد عاملة رخيصة ومؤهلة وتخضع لسيطرة الشرطة التي كانت تراقب الأحياء الشعبية بفضل آلاف المخبرين. وراء ”المعجزة“ كانت هناك مناطق مهملة وبطالة جماعية وسكان لم يعودوا يقبلون الفقر والفساد.
في عام 2008، ثار عمال حوض قفصة المعدني ضد إدارة المنجم التي كانت قد قامت بتعيينات اتسمت بالمحسوبية والمحاباة. على مدى ستة أشهر، ثار السكان ضد التعسف والبطالة التي أصابت ثلث شبابهم، في حين كان عمال المناجم يعملون بجد لاستخراج الفوسفات. كان الغضب الاجتماعي يتراكم.
وانفجر في نهاية عام 2010 في مدينة سيدي بوزيد، عندما أضرم بائع متجول شاب النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة بضاعته. هز هذا العمل اليائس البلاد بأسرها وكان نقطة انطلاق ”الربيع العربي“ الذي امتد إلى تونس ووصل إلى جميع البلدان العربية.
في تونس، وفي غضون أسابيع قليلة، ”سقط جدار الخوف“.
وانضمت إلى المطالب الاجتماعية مطالب سياسية مثل ”بن علي ارحل!“ و”الشعب يريد تغيير النظام“.
حصل بن علي على دعم ساركوزي ووزيرة خارجيته ميشيل أليوت ماري التي عرضت عليه ”خبرات قوات الأمن الفرنسية“ لإعادة استتباب الأمن. لكن الولايات المتحدة قررت، بالتنسيق مع قائد الجيش التونسي، التخلي عن الديكتاتور الخدوم، وذلك بهدف إعادة الاستقرار والحفاظ على مصالحها. وهكذا اضطر بن علي، ديكتاتور تونس لمدة 23 عاما، إلى السفر على عجل في رحلة بلا عودة إلى المملكة العربية السعودية.
في ربيع عام 2011، كان التونسيون فخورين وسعداء بنجاحهم في طرد ديكتاتور بدا أنه لا يمكن زعزعة مكانته.
|
|
لم يكن طرد الدكتاتور كافيا، بل كان لا بد من الإطاحة بالسلطة الاقتصادية التي كان يخدمها. فالنظام الاجتماعي الظالم، الذي تسبب في الكثير من المعاناة، لم يكن قائما على رجل واحد، مهما كان ثريا. رحل بن علي، لكن النظام الرأسمالي والدولة وجهاز قمع البرجوازية التونسية، الذي كان أداة النظام الإمبريالي، ظلوا في مكانهم.
أعقب سقوط بن علي فترة من الاضطرابات الاجتماعية، تخللتها مظاهرات وإضرابات عمالية واحتلالات. كانت الطبقات المضطهدة تكافح من أجل البقاء وتنتظر التغيير.
تأثرت الحياة السياسية بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي. وانسحب السياسيون المتورطون في الفساد، وعاد وزير سابق في حكومة بورقيبة، بيجي قايد السبسي. وأعيد السماح للأحزاب المحظورة، مثل الحزب الشيوعي التونسي (POCT) والجبهة الشعبية، وهي تجمع لقوى يسارية مختلفة، وحزب النهضة الإسلامي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.
وقد روج الجميع بأن انتخاب جمعية تأسيسية وإقامة الديمقراطية من شأنها أن تكون الحل للمضي قدما نحو التغيير. حتى حزب النهضة، الذي نفى سعيه إلى إقامة خلافة، شارك في هذا الترويج. وقد أعلن زعيم الحزب، راشد الغنوشي، أنه ينتمي إلى التيار الإسلامي المعتدل، وأن نموذجه هو أردوغان في تركيا. كان أنصاره قد تمكنوا من مقاومة القمع وأعادوا تنظيم أنفسهم بسرعة، واكتسبوا نفوذا في الأوساط الشعبية التي كانت الأحزاب الديمقراطية تتجاهلها بل وتحتقرها.
في أكتوبر 2011، فازت النهضة في انتخابات الجمعية التأسيسية وأصبحت القوة السياسية الأولى، كما لعبت دورا قياديا في الحكومة الانتقالية حتى عام 2014. على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، تصادم أنصار «التحديث» وأنصار الإسلام في الجمعية التأسيسية حول العديد من مواد القانون. ورغم اختلافهم حول العديد من القضايا، إلا أنهم كانوا يدافعون عن نفس الطبقة الاجتماعية، وهي البرجوازية وممتلكاتها الخاصة وحقها في استغلال العمال. ولم يقترحوا أي شيء لمعالجة الصعوبات الاجتماعية الكبرى التي كانت سببا في اندلاع الثورة.
لم يعد بن علي موجودا، لكن الفساد ظل موجودا في جميع مستويات المجتمع، وكان على العمال الكفاح بشراسة ضد نفس أرباب العمل، وكانوا يتعرضون للقمع من قبل نفس الشرطة. واستمرت غالبية التونسيين الفقراء في المدن والقرى في العيش في بؤس محبط.
وانتشرت الثورة التونسية في العالم العربي، وإن كنا لن نتطرق هنا إلى مصر والشرق الأوسط أو ليبيا والسودان.
|
لكن في المغرب، أدى الغضب إلى حركة 20 فبراير، التي نجح الملك في نزع فتيلها بإصلاح دستوري منح رئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات دون تغيير جوهري. وفي الجزائر، اتخذت الاحتجاجات شكل إضرابات ومظاهرات وأعمال شغب.
وفي الواقع، كان المغرب العربي قد بدأ يهتز لفترة طويلة.
2016-2017، حراك الريف المغربي
في خريف عام 2016، ثار سكان الريف المغربي مرة أخرى ضد الفقر. في هذه المنطقة الفقيرة، لا تزال ذكريات ثورة عبد الكريم ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي حية في الأذهان. في مدينة الحسيمة الساحلية، على بعد 300 كيلومتر من طنجة، أشعلت وفاة محسن فكري، بائع السمك، فتيل الفتنة. كانت الشرطة قد صادرت بضاعته وألقتها في شاحنة قمامة. وللاستعادة سمكه، قفز الشاب في الشاحنة فتعرض للسحق. انتشرت صور هذه المشهد المروع على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الغضب والعاطفة العارمين.
في الأيام التالية، احتج السكان بشكل جماهيري ضد عنف الشرطة وازدرائها وتعسفها. امتد الحراك إلى القرى المجاورة وتحول إلى حركة جماهيرية ضد الفساد والتهميش في المنطقة. ورفعت صور عبد الكريم وعلم جمهورية الريف في المسيرات. وكتبت على اللافتات السؤال الذي طرحه عبد الكريم في ذلك الوقت: ”هل أنتم حكومة أم عصابة؟“.
|
![]()
طوال أشهر، حشد السكان أنفسهم في مسيرات أسبوعية مطالبين بالإصلاحات ووضعوا قائمة من عشرين مطلبا.
أثارت قوة الحركة وطابعها السياسي المتزايد مخاوف السلطات المغربية من عودة الربيع العربي. فتم نشر 25000 شرطي لاحتواء المتظاهرين. وبأمر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، شن الأئمة حملة تشويه ضد الحركة. ردا على ذلك، قرر المتظاهرون مقاطعة المساجد. وعندما قاطع ناصر الزفزافي، شاب عاطل عن العمل ورمز للثورة، خطبة أحد الأئمة ليدين هجماته، تم اعتقاله على الفور وحكم عليه بالسجن 20 عاما!
واندلعت مظاهرات في عدة مدن في البلاد حيث تظاهر أكثر من 50 ألف شخص في شوارع العاصمة الرباط. وفي مواجهة هذا الحراك الذي كان يهدد بالامتداد، اشتدت حملة القمع. وفي منطقة الريف، قضت المحاكم على حركة الاحتجاج بإصدار أحكام قاسية بحق المتظاهرين. لكن محاكمات المعتقلين كانت فرصة لتعبئة جديدة، لكن السلطة نجحت في النهاية في إخماد الحريق.
لكن جمرة الثورة لا تزال موجودة، ولن تنطفئ أبدا، وستشتعل من جديد عندما لا يتوقعها أحد.
2019 والحراك في الجزائر
وهكذا، في الجزائر، في عام 2019، كان إعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين أنه كان عاجزا عن الكلام ومقعدا، بمثابة إهانة لا تطاق. فأثار بوتفليقة، الذي لم تمسه موجة التغيير خلال الربيع العربي، أكبر حركة شعبية منذ استقلال البلاد. وكما في تونس، نزلت جميع طبقات المجتمع إلى الشوارع للمطالبة برحيله. وطالب الشعب الجزائري بمساءلة السلطة التي أقيمت في أعقاب الاستقلال عام 1962، متهما كبار المسؤولين بنهب ثروات البلاد.
”إسقاط النظام!“ و”يتنحاو قاع“ (ليتنحوا جميعهم)، كانت هذه الشعارات تعني بالنسبة للطبقات الشعبية إنهاء القمع والاحتقار، والتمتع بالحرية والحقوق، والقدرة على إطعام أسرهم، وتلقي الرعاية الصحية، والحصول على سكن والعيش بكرامة.
لم تكن الطبقات الشعبية تتوقع شيئا من أحزاب المعارضة، الإسلامية والديمقراطية، التي كانت جميعها قد قدمت دعمها المباشر أو غير المباشر لبوتفليقة. وبعد أن تم رفضها، لم تتمكن أي من هذه الأحزاب من فرض نفسها كقيادة للحركة. نجح الحراك في طرد بوتفليقة ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن إذا كان ملايين الجزائريين، ومعظمهم من الطبقات الشعبية الذين تظاهروا لشهور، قد نجحوا في إسقاط واجهة النظام، فإن ذلك لم يكن كافيا. فبدون قيادة حقيقية خاصة بها وأهداف سياسية محددة، كان قايد صلاح، رئيس أركان الجيش، هو الذي فرض نفسه في نهاية المطاف مدعيا أنه يستجيب لمطالب الحراك، من خلال ”عملية تنظيف“ مذهلة وضع فيها خلف القضبان بعض كبار رجال الأعمال وكبار المسؤولين وعشرة وزراء وحتى رئيسان سابقان للوزراء.
لكن النظام لا زال قائما. وفي ديسمبر 2019، وبالرغم من دعوات المقاطعة، انتخب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، ليصبح الواجهة المدنية الجديدة لسلطة الجنرالات.
|
في تونس، انتهى الأمر بالطبقات الشعبية إلى رفض جميع الأحزاب التي كانت تطري عليها بالديمقراطية. في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، استغل قيس سعيد، أستاذ قانون متقاعد وغير منتسب إلى أي حزب، هذا الرفض. ففاز بسهولة على رجل الأعمال نبيل قروي، الذي كان حينها في السجن بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي! أمام مثل هذا الخصم، لم يجد قيس سعيد، الذي قاد حملة ضد الفساد، أي صعوبة في تجسيد تواضع ونزاهة الموظف الصغير! كما حاز هذا القومي المحافظ والمتدين على تأييد الرأي العام عندما هاجم النظام البرلماني.
وفي مارس 2022، وبالتنسيق مع الجيش، أصدر قيس سعيد قرارا بحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ. ثم أرسى أسس دستور جديد سمح له بتكميم أفواه المعارضين من جميع الأطياف. وحكم على زعيم حزب النهضة بالسجن ثلاث سنوات لمجرد إشارته إلى خطر اندلاع ”حرب أهلية“ في تونس.
وفي سبتمبر 2024، في انتخابات كانت نتائجها محسومة سلفا، أعيد انتخاب قيس سعيد رئيسا بنسبة 90,69٪ من الأصوات، لكن هذه المرة بنسبة مشاركة بلغت 28,8٪، وهي أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ عام 2011.
في الشهر نفسه في الجزائر، وفي مناخ قمعي وفي ظل مرشحين اثنين تم اختيارهما بعناية، أعيد انتخاب عبد المجيد تبون لولاية ثانية، ولكن هنا أيضا بمشاركة ضعيفة للغاية.
بعد 14 عاما من الربيع العربي، وبعد بضع سنوات من حركات الحراك المغربية والجزائرية، تنخرط الأنظمة في المغرب العربي في عملية هروب إلى الأمام تتسم بمزيد من الاستبداد، حيث يتم انتهاك الحقوق الديمقراطية ويداس على الحريات ويتم ملاحقة المعارضين. كل شيء هو ذريعة لفرض الانصياع، بهدف خلق جو من الخوف والوشاية.
إن التلويح بالمؤامرة الداخلية والتلاعب الأجنبي هي تهمة تستخدمها الأنظمة على نطاق واسع لاعتقال المعارضين الحقيقيين أو المفترضين. في تونس، تم مؤخرا الحكم على حوالي أربعين معارضا بالسجن لفترات طويلة لهذا السبب.
إن المئات من سجناء الرأي، الذين ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية، لقيامهم على سبيل المثال بنشر هاشتاغ #JeNeSuisPasContent ، لم يحظوا في فرنسا بنفس الدعم الذي حظي به الكاتب الفرنسي الجزائري بولعام سانسال. إننا ندين سجنه، كما ندين نفاق السياسيين، من اليمين المتطرف إلى جزء من اليسار، الذين يطالبون بالإفراج عنه ويتظاهرون بالدفاع عن حرية التعبير.
فأين هي حرية التعبير هنا في فرنسا عندما يحاول روتايو إسكات أولئك الذين يدينون سياسة نتنياهو الإجرامية، ويصفهم بأنهم معادون للسامية؟
أين هي حرية الناشط جورج إبراهيم عبد الله، المتهم دون دليل، والذي يقبع في السجون الفرنسية منذ أكثر من أربعين عاما؟
|
وفيما يتعلق بالمغرب العربي، لم نسمع أي احتجاج من قبل الديمقراطيين الفرنسيين المزعومين على مصير 200 سجين رأي في الريف المغربي محكوم عليهم بالسجن لمدة عشرين عاما! كما لم يحركوا ساكنا بعد إدانة الصحفي المغربي سليمان الريسوني، الذي كانت جريمته الوحيدة هي فضح المحسوبية والفساد اللذين يعصفان بالمغرب، كجميع مجتمعات المغرب العربي!
ماكرون وروتايو ولوبان وسيوتي من جهة، وتبون ومحمد السادس وقايد سعيد من جهة أخرى، هم أشقاء توائم، فهم مستعدون لاستخدام نفس الأساليب. هم والنظام الذي يخدمونه لا يستحقون سوى شيء واحد: الإطاحة بهم نهائيا!
لا يزال المغرب العربي جنة للشركات الفرنسية، حتى وإن كانت تواجه منافسة من شركات أخرى. يوجد 600 شركة فرنسية في الجزائر، و1000 في المغرب، و1500 في تونس. الشركات مثل توتال وأورانج وكارفور وبيجو ورينو، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة في قطاعات النسيج والطيران والإلكترونيات، توظف ما مجموعه 150 ألف عامل في تونس. النظام الاستبدادي لقايد سعيد لديه كل ما يدعوهم للاستثمار. أما الملكية المغربية، فهي تبدو لهم ضمانة للاستقرار الذي يساعد على ازدهار أعمالهم.
هذا الأسبوع، خصصت مجلة تشالنج (Challenge) صفحتها الأولى لهذا الموضوع، فوق صورة محمد السادس، يمكن قراءة العنوان التالي: ”المغرب، على عكس الجزائر : رهان فرنسا وجنة للأعمال“. إن هذا العنوان يلخص كل شيء!
فبالفعل، استفادت شركات Colas Rail و Thalèsو Engieو Neoبشكل كبير من مشروع قطار الدرجة الأولى الذي تقدر تكلفته بـ1.1 مليار يورو. وتمكنت شركة Alstom من بيع اثني عشر قطارا دون المشاركة في أي مناقصة بفضل خدمة قدمها لها محمد السادس، الذي تحول من ملك الفقراء إلى ملك الرأسمالية المغربية. وتكشف مجلة Challenge أنه يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد المغربي، أما ثروته الشخصية، التي قدرت بـ 5.7 مليار دولار في عام 2015، فقد زادت بشكل كبير.
من جانبه، يعد رئيس الوزراء المغربي العزيز أخانوش من أوائل أصحاب الثروات الخاصة في البلاد. وهو رئيس مجموعة أفريقيا(Afriquia) ، أكبر شركة لتوزيع الوقود. وقد وقع، بصفته رئيسا للحكومة، عقدا مع ثلاث شركات، من بينها شركته العائلية، لبناء محطة كبيرة لتحلية المياه في الدار البيضاء. وكما أن المرء لا يخدم نفسه أفضل من نفسه، فقد منح نفسه إعانة بمليارات الدراهم.
مع بناء بنية تحتية حديثة مثل ميناء طنجة المتوسط، والقطار السريع بين الدار البيضاء وطنجة، ومناطقها الصناعية ومحطات طاقة الرياح، ومزارعها الضخمة، ومراكزها التجارية اللامعة، وفنادقها الفخمة، يقدم المغرب كنموذج للنجاح والتنمية. لكن وراء واجهة الساحل تختبئ مظاهر الفقر، ومعدل أمية يبلغ 30٪، ومدارس متهدمة، وطرق غير سالكة، وأحياء فقيرة، كما اتضح خلال زلزال في شهر سبتمبر 2023.
هذه التفاوتات والفقر موجودة في كل مكان في المغرب العربي. ومن أجل إغراق السوق الأوروبية بالفواكه والخضروات، استولت بعض العائلات المغربية والتونسية الثرية على أفضل الأراضي و85٪ من المياه، في حين أن الريف يعاني من الجفاف.
|
![]()
|
اليوم، من الرباط إلى تونس مرورا بالجزائر، يعاني العمال من هجمات أرباب العمل الذين يستغلون البطالة لفرض ظروف عمل مزرية. ففي طنجة بالمغرب، الغالبية العظمى من 55 ألف عاملة، اللواتي يعملن في 417 مصنعا للنسيج، هن غير مسجلات قانونيا. في 8 فبراير 2021، عقب فيضانات، لقي 28 عاملا، بينهم 20 امرأة، حتفهم غرقا في مصنع يقع في طابق سفلي. لم يتم استجواب صاحب المصنع قط، بينما تعرضت عائلات الضحايا التي طالبت بالعدالة للترهيب من قبل الشرطة. وفي العام الماضي في بومرداس في الجزائر، لم يتم فتح أي تحقيق عندما لقيت عشر عاملات في مصنع للولاعات حتفهن حرقا جراء انفجار خزان غاز.
هؤلاء العمال والعمالات، الذين يستغلهم أرباب العمل المحليون أو الأجانب، يعانون في جميع أنحاء المغرب العربي من ظروف عمل ومعيشة متشابهة للغاية.
فهم يواجهون نفس الأجور المتدنية، ونفس التضخم، ونفس المراقبة المستمرة، ونفس اندماج النقابات في الأنظمة القائمة. وقد ثار بعضهم مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة، وواجهوا القمع بشجاعة، وكافحوا ضد ما أسموه "النظام".
لكن "النظام" الذي يقمعهم ويجب عليهم الإطاحة به ليس فقط أجهزة الدولة وأجهزة الشرطة والجيش التي تزداد قسوة في كل بلد من هذه البلدان وبالتواطؤ مع الدولة الفرنسية.
إن النظام الذي يستغلهم هو الرأسمالية التي أخضعت الكوكب بأسره لسيطرتها، وحولته إلى كيان اقتصادي واحد، وربطت جميع العمال بمصير واحد.
الروابط التي تجمع بين عمال المغرب العربي، والروابط التي تجمع بين العمال على جانبي البحر الأبيض المتوسط، ليست مجرد روابط عائلية أو روابط نسجتها تاريخ طويل مشترك. هؤلاء العمال مرتبطون بنفس سلسلة الاستغلال ويعملون على إثراء نفس البرجوازية.
إلى البرجوازية الفرنسية القديمة، مثل بويغ، بيجو، أرنو وشركائهم، انضم عدد من البرجوازيين المغاربة والجزائريين والتونسيين الذين كانوا أكبر المستفيدين من الاستقلال.
الطريق المسدود الناتج عن السياسات الوطنية
بعد 60 عاما من الاستقلال، عاشت الطبقات المضطهدة في المغرب العربي تجربة مريرة، حيث أدركت أن نهاية الاستعمار لا تعني نهاية الفقر.
لقد أنشأ القادة القوميون دولا انصهرت في الهياكل الموروثة من الاستعمار، وأصبحت ضامنة للنظام الإمبريالي. محمد السادس وتبون وقيس سعيد يلعبون جميعا دور حراس الحدود نيابة عن الاتحاد الأوروبي. إنهم يطردون بوحشية المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.
أما الدور المساعد للنظام الإمبريالي في منطقة الساحل، الذي طالما لعبته الجزائر في مواجهة الميليشيات الجهادية، فقد عهدت به الولايات المتحدة وفرنسا مؤخرا إلى المغرب.
كما قدس القادة القوميون الحدود الموروثة عن الاستعمار التي تفصل بين الشعوب وتعيق تنقلها.
وقد تم تقديم إنشاء دول منفصلة، مع أناشيدها وأعلامها، إلى شعوب المغرب العربي على أنه السبيل الوحيد للتحرر، في حين أن ذلك يقسمها ويغذي الصراعات فيما بينها. واليوم، تشكل الحدود، بجدرانها الرملية وأسلاكها الشائكة، قضبان سجن حيث تتعرض الطبقات المضطهدة للاستغلال المزدوج.
|
كم من الشعوب التي كافحت بشدة من أجل استقلالها، في أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى من العالم، عانت هذه التجربة المريرة؟
في المغرب العربي، حيث تفاقم قضية الصحراء الغربية التوترات، ما هو مستقبل الشعب الصحراوي؟ التبعية الإسبانية أو المغربية أو إنشاء دولة صغيرة ضعيفة؟ لا يمكن لأي من هذه الحلول أن توفر آفاقا حقيقية.
بالطبع، ليس للدول المجاورة القوية، ولا للقوى الإمبريالية، المهتمة بالثروات الكامنة في باطن الأرض، أن تقرر مستقبل الصحراء الغربية. إن الشعب الصحراوي، وحده، هو الذي يقرر مصيره!
لكن المستقبل لا يمكن أن يكون ضمن المغرب أو الجزائر اللذين يقمعان شعبيهما. إن المستقبل يكمن في إقامة فيدرالية أخوية تضم جميع الطبقات المضطهدة في المغرب العربي!
الصراع الطبقي بدل الاكتفاء بالإطاحة بالسلطة
شهدت بلدان المغرب العربي، قبل الاستقلال وبعده، صراعات متواصلة اتخذت أحيانا شكل انفجارات اجتماعية حقيقية ومستمرة وحازمة. لكنها اصطدمت في كل مكان بنفس الجدار. لا شك في أن الثورات ستتكرر في جميع أنحاء المغرب العربي وحتى في بقية العالم العربي. لا يسعنا إلا أن نتشارك الغضب الذي يحرك بشكل دوري العمال والشعوب في تونس والجزائر والمغرب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه عليهم، والذي يجب أن نطرحه معهم، هو مسألة الآفاق السياسية.
تنطلق جميع الانتفاضات الشعبية من ثورة ناجمة عن انتهاكات وظلم النظام الاقتصادي والسياسي. كان هذا هو الحال بالنسبة لانتحار محمد البوعزيزي في تونس عام 2010، أو وفاة بائع السمك الشاب الذي سحق في شاحنة قمامة في المغرب عام 2016. لكن هذه الانفجارات الغاضبة يجب أن تجد منفذا لها. العمال والطبقات المستغلة، التي كانت في طليعة هذه الحركات، تحركت دون وعي بقوتها ومصالحها كطبقة متميزة. وهناك قوى سياسية لا تعد ولا تحصى مستعدة لاستغلالها وتوجيهها لتقودها في النهاية إلى طريق مسدود. وهذا يشمل مختلف أنواع الدعاة الإسلاميين، من الجنرالات إلى السياسيين الخبراء في تجميل الواجهة الديمقراطية، وذلك في سبيل الحفاظ على النظام القائم.
لذا، فإن السياسة التي تكتفي بقول "ارحل" للسياسيين الحاليين ليست كافية. فعندما يرحل سياسي، يخرج عشرة آخرون من جحورهم ليحلوا محله. على العكس من ذلك، يجب أن تستخدم الطاقة التي يتم بذلها خلال هذه الحركات للتقدم حقا بخطوة نحو الثورة. نحو ثورة تهاجم النظام الرأسمالي نفسه والإمبريالية.
![]()
إن الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية يجري على نطاق كوكب الأرض. وعلى هذا النطاق وحده يمكن محاربة الرأسمالية، لأن هذا النطاق وحده هو الذي يسمح بتنظيم الاقتصاد بشكل أفضل. لن يكون بالإمكان حل التحديات التي تواجه البشرية، في المغرب العربي كما في أي مكان آخر، إلا على الصعيد الدولي!
وعلى الرغم من الحدود التي تفرقهم، يجب أن ينجح العمال في مختلف البلدان خلال هذه الحركات في زيادة وعيهم الطبقي والتقارب حول برنامج الثورة البروليتارية، برنامج الثورة الاشتراكية العالمية.
يجب أن يتبنى العمال هذا البرنامج عاجلا أم آجلا، لأن ثورات وحركات أخرى ستندلع حتما. لكن ما ينقصنا أكثر هو الرجال والنساء والناشطون والأحزاب الذين يدافعون خلال هذه الثورات، سواء في المغرب العربي أو هنا في فرنسا وأوروبا، عن برنامج الثورة البروليتارية العالمية، البرنامج الوحيد القادر على إعطاء أفق حقيقي لجميع نضالات الطبقات المستغلة.
مصدر النص: https://www.union-communiste.org/ar/lnsws-bllg-lrby
النص باللغة الفرنسية: https://www.lutte-ouvriere.org/portail/cercle-leon-trotsky/maghreb-les-p...